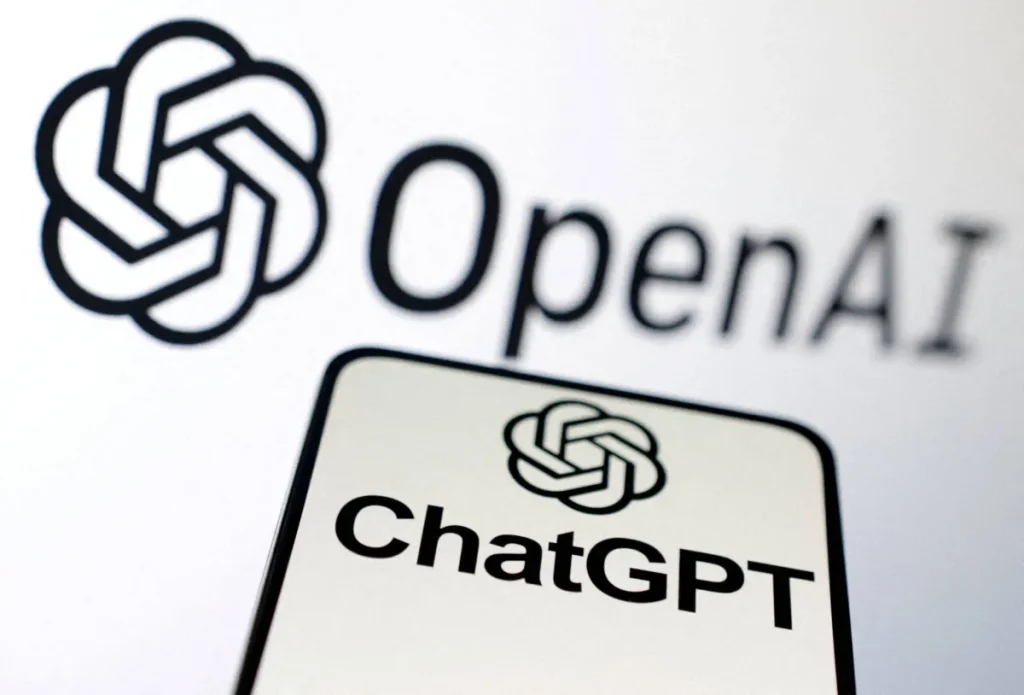منذ أن تسلّل نظام الذكاء الاصطناعيّ الأشهر «تشات جي بي تي» إلى الفضاء الرقمي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أخذت اللّغة – ذلك النهر الخفي الذي تجري فيه أفكار البشر- تتغيّر ملامحها بصمتٍ لكن بشكل تراكميّ، ولم تعد الكلمات التي نستخدمها للتعبير اليومي تنبثق فقط من عاداتنا القديمة أو معاجمنا المتوارثة، بل بدأت أعداد متزايدة منها تُستدرج، كلمةً تلو أخرى، من تلافيف العقل السيبيري البارد إلى دفء الحياة البشريّة.
هذا على الأقل ما يعتقده علماء من معهد «ماكس بلانك لتنمية الإنسان» في برلين، رصدوا بحراً هائلاً من الكلام البشري – أكثر من 740 ألف ساعة من المحاضرات الأكاديمية والنقاشات العامة وحوارات البودكاست – ليلمحوا أن هناك وسط المليارات من الكلمات، تغيّراً لا يمكن تجاهله: مفردات بعينها أخذ يرتفع معدل استخدامها في المحاضرات وعلى الشاشات والميكروفونات فجأة، لتتصدّر المشهد اللغوي خلال شهور قليلة من إطلاق «تشات جي بي تي» للعموم.
كلمات قليلة محددة كانت قبل ديسمبر 2022 هامشية في محادثاتنا اليومية مثل «يتعمّق»، «يفتخر»، «يفهم»، «سريع»، «دقيق» والتي وكأنها منسوخة من لسان «تشات جي بي تي»، صارت الأكثر ترداداً على الألسن بمناسبة ومن دون مناسبة.
وتقول دراسات أخرى للظاهرة ذاتها إنها لا تقتصر على فضاءات الاستخدام العفوي غير المقيّد للكلمات، مثل حوارات البودكاست مثلاً التي تبدو وكأن «تشات جي بي تي» كان ثالث كل مذيع وضيف فيها، بل امتدت إلى النصوص الأكاديمية المعدّة مسبقاً. المفردة الأكثر دلالة هنا كانت «يتعمّق» التي يوظفها قاموس «تشات جي بي تي» بكثرة لا كمجرد فعل، بل كما وعد بالتنقيب في حفريات المعرفة التي تستدعي وقار البحث الأكاديمي ورصانته. وسجلت الدراسة أنّه في غضون أشهر من ديسمبر 2022، تضاعف استخدامها في المحاضرات، وكأنها أصبحت جواز مرور إلى الخطاب الأكاديمي الذي يفترض به أن يكون الأرفع والأكثر أصالة.
وبحسب دراسة للأوراق الأكاديمية المنشورة عام 2024 عبر العالم فإن 13.5 في المائة من ملخصاتها تحمل بصمات معالجة أو صياغة بأدوات ذكاء اصطناعي، لتصل النسبة في بعض التخصصات والمؤسسات إلى 40 في المائة. والأخطر أن هذه الإضافات الأسلوبية – التي يغلب عليها مزاج استخدام أفعال معينة – غالباً ما تكون غير مرتبطة مباشرة بالمحتوى العلمي، لكنها تمنح النصّ مسحة من الديناميكية والانسياب، كما لو أن الغاية لم تعد إيصال المعلومة، بقدر ما تتعلق باستيفاء شكل جمالي موحّد.
ومن اللافت أن أثر لغة الذكاء الاصطناعي لم يتوزع بالتساوي بين فروع العلم؛ إذ إن التعليم، والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال بدت أكثر انفتاحاً على هذه البذور اللغوية الصناعية، بينما بقيت مجالات الدين والرياضة شبه عصيّة على العدوى. وكأن اللغة، مثل أي كائن حي، تنتقي التربة التي تجد فيها فرصة للإنبات.
ولأن الشكّ منهج العلم، لجأ الباحثون إلى أدوات التحليل السببي – ما يُعرف بـ«التحكم الاصطناعي» – لمحاكاة عالم بديل لم يظهر فيه قاموس كلمات «تشات جي بي تي» قط. والنتيجة جاءت حاسمة: الفارق بين العالمين أكبر من أن يُفسّر بمحض الصدفة.
ويقول العلماء إن المسألة لا تقف عند حدود التقليد. فحين نختار «يتعمّق» مثلاً بدل «يبحث»، فإننا لا نبدّل اللفظ فحسب، بل نغيّر زاوية النظر، ونغرس في العبارة نبرة، ومنهجاً، وقيماً ضمنية. فالأولى تستدعي مشهد الباحث الذي ينقّب بحذر في طبقات معرفية كثيرة، بينما الثانية تحيل إلى فعل مباشر لا ينشغل كثيراً بغير شكليات الطقوس الأكاديمية. وحين تُكرَّس مثل هذه الاختيارات في الكلام، فإنها تبدأ تدريجياً في تشكيل أفق التفكير الإنساني نفسه.
ليست هذه الظاهرة الأولى من نوعها في التّاريخ اللغوي، لكنها تختلف هذه المرّة في سرعتها وعمقها. فحين ظهرت المطبعة في أوروبا القرن الخامس عشر، تغيّر شكل النص وتوحّدت أنماط الكتابة، لكن التغيير استغرق أجيالاً. وعندما دخل الراديو والسينما والتلفزيون إلى كل بيت، تغيّرت نبرة الكلام وأوزان الجمل، لكن ذلك جرى عبر عقود. أما اليوم، فالتأثير يهبط علينا كالمطر الغزير، يبلّل مفرداتنا ويعيد تشكيلها في غضون أشهر أو سنوات قليلة، لا قرون.
ويحيلنا القائمون على الدراسة حول التساؤل المستحق عن تأثير هذه البصمة اللغوية للآلة إلى منطق «الدائرة الثقافية المغلقة»؛ حيث النماذج اللغوية للذكاء الاصطناعي تتغذى على اللغة البشرية، ثم تعيد إنتاجها وفق تفضيلاتها، فيتبنّاها البشر، فتعود هذه اللغة المعدّلة لتغذية النماذج اللاحقة. ومع كل دورة، تضيق فسحة التنوع الأسلوبي، وتتراجع اللهجات والأنماط الهامشية أمام مركز لغوي واحد، فائق النعومة، شديد الانضباط، كثير الشبه بنفسه.
وهذه بالطبع ليست فروضاً قسرية، بل هيمنة ناعمة. فالنماذج مثل «تشات جي بي تي» لا تفرض على المستخدم أن يتبنى أسلوبها للتواصل، لكنها تمنحه – من خلال الإيحاء الاجتماعي والمكافآت النفسية غير الملحوظة – شعوراً بالرضا عن الذات للظهور بشكل أكثر احترافية، وأكثر وضوحاً، وربما أكثر ذكاءً حين يتحدث بلغتها. وهكذا، يصبح أسلوب الآلة معياراً غير معلن، يُقاس عليه «جمال» النص و«قيمة» الخطاب، بينما يُدفع من يكون مغايراً بشكل تدريجي إلى الهامش نحو مساحات تُصنّف ضمنياً على أنها أقل رصانة، أو أقل مهنية.
وما يزيد الأمر تعقيداً أن التأثير لا يطول فقط مستخدمي الذكاء الاصطناعي المباشرين. فالمفردات والأساليب التي يولدها تتسرّب عبر المقالات الإخبارية، والكتب، والمراسلات المهنية، وحتى النكات على وسائل التواصل. وهكذا، حتى لو لم يتعامل الشخص مع «تشات جي بي تي» يوماً، فإنه سيجد نفسه وقد استعار كلمة أو تعبيراً لم يكن جزءاً من قاموسه الذاتي، بحكم أنه سمعه يتردّد على ألسنة آخرين، أو قرأه في نص بدا له محترفاً ومنساباً. إنها عدوى لغوية صامتة، تتنقل عبر الكلمات من شخص إلى آخر، ومن نص إلى آخر، حتى تغدو مألوفة لدرجة أننا ننسى غرابتها الأولى.
إن الجنس البشري يقف اليوم برمته أمام هجمة متسارعة لاستعمار ناعم بمفردات الآلة. فالمفردات، مثل أي حامل ثقافي، ليست حيادية، بل تجر وراءها رؤية للعالم، وتصوراً لعلاقات القوّة، وحتى شكلاً للذات. والواقع أننا بعد سنوات قليلة من انطلاق هذا الاستعمار صار لنا أن نقلق إلى أي مدى ستبقى اللغة مرآة للإنسان، ولا تمسي انعكاساً لآلة تتقن تقليده حتى حدّ استبداله.
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}