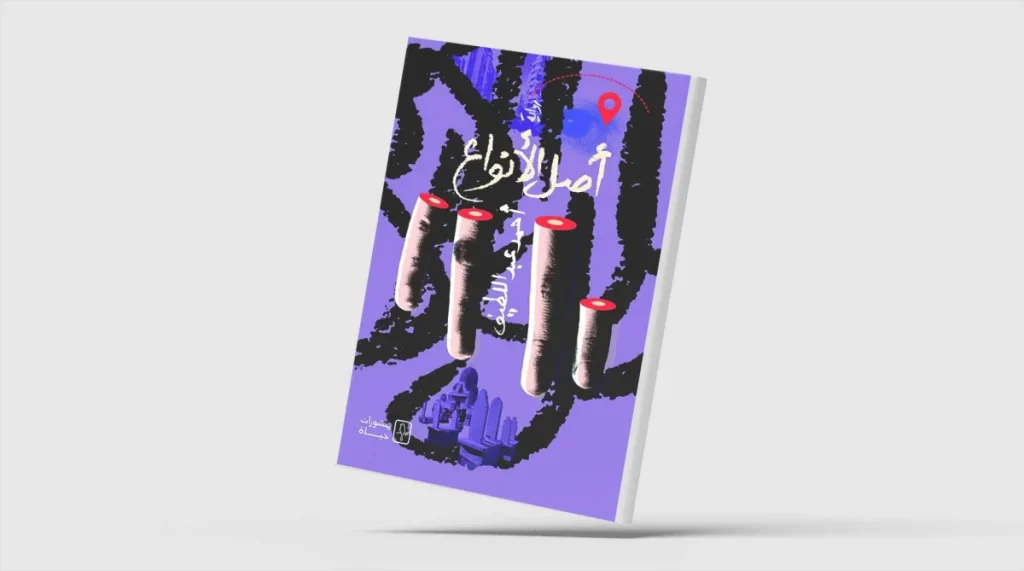تنطلق رواية «أصل الأنواع» للكاتب الروائي المصري أحمد عبد اللطيف من تفاعل فني مع نظرية التطوّر لتشارلز داروين، ولا تقف عند حدود الإحالة إلى المصطلح العلمي بقدر ما تُزيحه نحو أفق أرحب يشتبك مع سؤال «ما بعد الإنسان»، فلا يصير «التطوّر» مجرد مسار بيولوجي خطيّ، بل يتسع لإعادة التشكيل فنياً، ضمن شبكة من الأبعاد التاريخية، والعاطفية، واللغوية.
منذ المشهد الافتتاحي في الرواية، الصادرة أخيراً عن «منشورات حياة» بالقاهرة، يمد الكاتب خيطاً دقيقاً بين الخاص والعام، بين الحقيقة والوهم، والحلم والواقع، ليُلقي بالقارئ داخل رأس بطله «رام»، الذي تتزاحم داخله خيبات فقد عاطفي جديد مع صخب الحفر في قلب القاهرة، حيث يُكلَف «رام» المهندس المدني بمهمة تنفيذ مُخطط توسعة و«تطوير» يتضمن هدم مقابر القاهرة القديمة، لكن الصدمة الأعمق تأتي في لحظة سوريالية يفقد فيها شَعره فجأة، لتتحوّل هذه الحادثة الفردية إلى ظاهرة تتسع على مدار الرواية، وتشمل سكان المدينة بفقد متنوع، من الشعر والأصابع والأطراف، إلى المشاعر والروابط الإنسانية، في سيرورة تنكسر فيها الحدود بين الجسدي والمعنوي.
هنا يتجاوز الفقد كونه وباءً غامضاً ليغدو استعارة عن فكرة الأطراف والزوائد «الداروينية»، إذ يُستعاد الإنسان المعاصر في صورة كائن منقوص، وكأن مسار التطوّر يسير عكسياً، ليُعيد تشكيل نسخة بدائية من الإنسان، في مفارقة حول هشاشة ما نعتبره تقدماً.
مسار تأملي
يمهّد هذا الاتصال الوشيج بين الجسد والمدينة في الحياة إلى امتداد موازٍ مع الموت، فتصير المقابر «مدينة الموتى» متصلة بالمدينة الحيّة عبر توظيف سوريالي تصنعه الرواية، ويتحوّل التطوّر الجديد للمدينة، من هدم ونبش للمقابر القديمة، إلى مشهد يتعايش فيه الناس في المقاهي والطرقات مع موتى بأكفان بيضاء متربة يسيرون بظهورهم بين المارة، كأن المدينة كلها صارت تعيش على الحافة بين عالمين.
هذه الغرائبية جعل الكاتب مدخلها هو العالم النفسي لبطله «رام»، حيث لا يمكن فصل ملامحه النفسية عن جغرافيا المدينة التي يسكنها وتسكنه؛ فخوفه المتأصل منذ الطفولة، الممتد من ظلمة الغرف إلى الخوف من الأشباح في البيت، يجد في القاهرة مسرحه الأوسع، وحين تموت زوجته وحب حياته «نيفين» لا ينتهي حضورها في قبر، بل تتحوّل إلى شبح يلازمه، يتسلل إلى ذاكرته وهواجسه، وحتى علاقاته العاطفية الجديدة.
هكذا تفتح الرواية مساراً تأملياً وفنياً حول تطوّر الحب باعتباره «أصلاً» له نسخ وأشباح، فيصبح الحب الجديد إعادة عبور إلى «مدينة نيفين» بطريقة أو بأخرى، وكأن العاطفة ذاتها تخضع لمسار تطوّر خاص بها.
هذا التشابك بين الجسد والمكان يتعزز عبر لعبة السرد التي تمزج الواقع بالمُتخيّل، وتشتق من سؤال السعادة سؤالاً وجودياً لا يخلو من عدمية: «حياتنا مادة سائلة تصب في قالب صلب وثابت لم نختره بمحض إرادتنا هو الوجود»، فالبنية السردية السيّالة، الخالية من الحواجز الصارمة بين الواقع والحلم، والحياة والموت، تجعل القارئ على الحافة بين ما يراه «رام» وما يتخيله، أو يتمناه ويخشاه. ويتجه السرد إلى استبصار ما قد يؤول إليه إنسان مدينة يُهدم قلبها، بتاريخها وتراثها ومقابرها القديمة، وما قد يقوده فقْد العاطفة والغريزة البشرية تباعاً، فلا يتغيّر شكل الجسد وحده، بل يُعاد تعريف الحب والسعادة نفسها، فيتخذ التطوّر العكسي بُعداً جسدياً ووجودياً في آن واحد.
أبجد هوز
لا ينفصل انشغال الرواية بفكرة ما بعد الإنسان عن فلسفتها الجمالية، إذ تشتغل على إعادة صياغة العلاقة بين الأصل والبديل، وبين الفقد والتحوّل، لتطرح أسئلة جوهرية حول موقع «الإنسان الجديد» في مسار تطوّر قد لا ينتهي بالارتقاء، بل ربما بالارتداد، وحول المدن التي تبني أجسادنا وهُويتنا بقدر ما نبنيها نحن «المدينة لم تعد مدينة طفولته وشبابه، بل صارت أخرى غريبة، وهو نفسه من يساعد في غرابتها، وفي إخفاء معالمها هو نفسه يد تمحو ذكرياته، وهو نفسه قدم تطأ وجهها بما تحمله من براءة وتيه».
وتعزز البنية الفنية للعمل كذلك من اشتباك الرواية مع سؤال التطوّر، بداية من اختفاء علامات الترقيم على امتداد العمل بما تطرحه من سؤال حول تحرير النص، وإعادته إلى بدائية السرد وسيولته، وصولاً إلى تقسيم الأحداث على مدار أسبوع واحد، مُستعار من القاموس المسيحي لأسبوع الآلام، فيستدعي فكرة تطوّر الألم ذاته، من لحظة «أحد الزعف» إلى بلوغه ذروة الفقد في «سبت النور»، ثم تفتيت هذه الأيام إلى فصول قصيرة تحمل الحروف جذور الأبجدية الأولى «أبجد هوز» وتُحيل إليها، كأن الرواية تستعيد مسار تطوّر اللغة من بداياتها ليغدو البناء الفني نفسه مرآة لمسار مزدوج؛ من تطوّر اللغة وتحوّلات الألم.
تتّسع الرواية لتحتضن أبطالها في حيّ واحد، بداية من «رام» المهندس المدني، مروراً بسيد «بتشان» بائع الفاكهة، ولاعب كرة القدم «يحيى الحافي»، ليجمعهم السرد في مرمى تطوّر المدينة الذي يضعهم في مفارقات لا تخلو من فانتازيا وسخرية سوداء، بينما تكشف لغة الرواية، رغم خضوعها لسلطة راوٍ عليم واحد، عن حساسية خاصة تجاه العوالم المتباينة لشخصياتها، وعن قدرتها على التقاط لحظات التبدّل التي تفرضها خسارة الأطراف، أو تبدّل ملامح الحب والقدر.
في هذا العالم، تصبح الأطراف الناقصة جزءاً من معمار السرد، لا باعتبارها علامة على النقص فقط، بل باعتبار أنها شرط جديد للتكيّف مع العالم الجديد، وبينما يتعامل الأحياء مع هذا النقصان على أنه واقع لا مهرب منه، يُطلّ الموتى في المشهد العام بوصفهم مرآة مقلوبة، لنصبح أمام أحياء يتقدّمون في الحياة ناقصين، وأموات يسيرون للخلف، في تداخل مربك يجعل الحدود بين الحياة والموت مجرّد خط وهمي قابل للعبور في أي لحظة: «ستكون القرافة رحماً كذلك، لكنه رحم مختلف يلِد الموتى من جديد، لكن ليس في العالم الآخر، بل في عالمنا نفسه».
“);
googletag.cmd.push(function() { onDvtagReady(function () { googletag.display(‘div-gpt-ad-3341368-4’); }); });
}