ما الذي يمكن قوله عن الكاتب المكسيكي خوان رولفو (1917-1986) في ذكرى ميلاده، وقد مر أكثر من قرن على هذا الحدث؟ أما زالت هناك حاجة لتسليط الضوء على تأثيره في الأدب العالمي، أم أن مكانته أصبحت راسخة بما يكفي لننتقل إلى زاوية أجدى بالتأمل؟
كلما توغلنا أكثر في دروب القراءة، اتضح لنا، أن هناك نوعين من الكتب: كتب نطويها قبل أن نبلغ الصفحة الأخيرة، وأخرى تطوينا داخلها حتى بعد أن تجد طريقها إلى الرف بمنتهى العرفان. لكن رواية بيدرو بارامو، لا تنتمي إلى هذا النوع أو ذاك.
إنها من تلك الفلتات التي أعجزت كاتبها لدرجة ألزمته الصمت خمسة عشر عاما، قبل أن يصدر عملا آخر وأخيرا، لم ينل ما نالته روايته الأولى التي تستعصي على التصنيف. وإن كنا نستطيع أن نصفها، حتى بعد مرور ما يقرب من سبعين عامًا على صدورها، ببئر عميقة، أو بثقب أسود يبتلع كل ما يقع في مجاله، فهي باختصار: رحلة في اتجاه واحد، تذكرة ذهاب بلا عودة.
لا أنصحك بالذهاب إلى كومالا
رغم أن شهرة رولفو تدين لعملين فقط، “السهل يحترق” (1953) و”بيدرو بارامو” (1955)، فإنه يُعد أحد أعمدة الأدب اللاتيني الحديث، وأحد الآباء الروحيين للرواية الجديدة في أميركا اللاتينية. وقد اعترف كتاب مثل “غابرييل غارثيا ماركيز” و”كارلوس فوينتس” بفضل “بيدرو بارامو” في فتح آفاق التجريب السردي أمامهم، على النقيض، وجد بعضهم في انتقال رولفو من الواقعية في “السهل يحترق” إلى السحرية في “بيدرو بارامو”، انقلابا غير مفهوم، ولم يفكروا ولو لحظة واحدة في تطور الصوت الفردي في قصص المجموعة إلى همس جماعي في الرواية، عندما تحولت الهموم الشخصية إلى هم مشترك، ليصهر الجميع في أتون واحد اسمه كومالا.
أكثر ما يؤكد الزعم السابق هو أن اسم “بيدرو” يأتي من الجذر اللاتيني “Petrus” الذي يعني “الصخرة”، أما بارامو “paramo” المشتقة من الإسبانية تعني “السهل القاحل”. هل ينبهنا رولفو إلى أن “بيدرو بارامو” هي السهل بعد أن احترق فعلا؟ وهل يمكننا بناء على اللغة اعتبار المجموعة القصصية الأولى بمثابة إنذار بالكارثة؟ بمعنى آخر، هل أراد أن يصرخ أولا وهو بكامل واقعيته، ثم انتقل إلى السحرية عندما استحالت الإغاثة؟
إن عنوان المجموعة يعكس صراعا أوليا، معركة ضد الوقت، ضد الفناء. أما “بيدرو بارامو”، تمثل المرحلة اللاحقة بعد أن تسرب الوقت، وأجهزت النيران على كل شيء، فإذا بكومالا تتحول تدريجيا إلى مدينة الأشباح!

التجول في مدينة الأشباح
من الصعب على أي قارئ الدخول إلى أجواء رولفو الواقعية، ناهيك عن كومالا؛ المدينة التي تشكل فضاء روايته الأولى. لكنّ قارئا شغوفا ستسحبه قدماه لا محالة، وما إن يعافر لوضع قدميه على أرضها المحترقة، حتى يدرك أن لا سبيل إلى العودة. الأكثر مدعاة للرعب، أن هذا القارئ الشغوف، غالبا ما تبوء محاولاته في الانتقال إلى حكاية أخرى، بالفشل الذريع، كأن لعنة كومالا تلبسته، ومن المؤكد أن تلك اللعنة ستدوم طويلا، وهو لا يزال عالقا هناك بين أهلها المنسيين الذين لم تسعهم الأرض في حياتهم، ولم تقبلهم السماء بعد موتهم، فظلوا عالقين بين بين، يستغيثون بأي كائن حي، دون وعد بالخلاص.
أهذا هو سر فرادة رولفو؟ أهي قدرته على قتل بطله وسجن قارئه داخل النص؟ أم أن السؤال الملح على كل من دخل كومالا طوعا أو رغما: كيف يمكنني الخروج من هنا؟
يتكشف جوهر كومالا كقرية ابتلعها الخراب في كل تفصيلة، بدءا من الطريق الذي يأخذ في الانحدار للوصول إلى شوارعها المهجورة وبيوتها ذات الأبواب المشققة والتي غزتها عشبة الحاكمة. مرورا بالوصف المخيف على لسان الشخصيات كما تقول داميانا خادمة بيدرو بارامو:
.. وفي أيام الهواء تأتي الريح ساحبة معها أوراق أشجار، وهنا كما ترى، لا توجد أشجار. لقد كانت الأشجار موجودة في زمن مضى، وإلا من أين تأتي هذه الأوراق؟
إن الماضي لم يغادر المكان، ولا أمل له في مغادرته، لقد سُجن بكامله هنا متراكما فوق بعضه، ليفزع كل من دخل إلى ساحته، لكن الأكثر مدعاة للرعب، كما تسترسل داميانا:
هو عندما تسمع الناس يتحدثون، وكأن الأصوات تخرج من شق ما… والآن بالذات، بينما أنا آتية، مررت بجماعة تسير حول ميت. فتوقفت لأصلي أبانا الذي في السماوات. وكنت أفعل ذلك، عندما انفصلت امرأة عن الأخريات وأتت لتقول لي: داميانا! تضرعي إلى الله من أجلي يا داميانا! ونزعت خمارها فتعرفت على وجه أختي سيبينا.
– ما الذي تفعلينه هنا؟ – سألتها.
عندئذ هرعت لتختبئ بين النساء الأخريات.
وأختي سيبينا، إذا كنت لا تعرف، ماتت عندما كان عمري اثنتي عشرة سنة… وهكذا بإمكانك أن تحسب كم من الزمن مضى على موتها. وها هي الآن، ما زالت تهيم على وجهها في هذه الدنيا. ولذا لا تفزع إذا ما سمعت أصداء أحدث عهدا يا خوان بريثيادو.
(ترجمة صالح علماني)
لاحقا، يكتشف القارئ أن داميانا نفسها، ماتت منذ زمن لا نعرفه، وكذلك دونيا أدوفيخس أول امرأة استقبلته في بيتها. ويتعزز هذا الطابع الشبحي في حوار أخت دونيس التي اتخذها زوجة بعد أن فرغت القرية من أهلها ولم يجد خليلة سوى شقيقته:
“لو أنك ترى حشود الأرواح التي تهيم في الشوارع. عندما يخيم الظلام تبدأ بالخروج. إنهم كثيرون، ونحن قليلون جدًا، حتى أننا لا نتكلف مشقة الصلاة من أجلهم لتخليصهم من آخرتهم، لأن صلواتنا لن تكفيهم جميعًا. ربما ينال كل منهم جزءًا من ‘أبانا الذي في السماوات’، وهذا لن يفيدهم في شيء.”

الواقعية قبل أن تسحرنا
ولد رولفو في 16 مايو/أيار 1917، ورحل في يناير/كانون الثاني 1986، لينتمي إلى جيل تأثر مباشرة بتبعات الثورة المكسيكية (1910–1920) والحرب الأهلية التي تلتها، جيل لم يكن ابنا للثورة، بقدر ما كان ضحية لخيبتها. هكذا ولدت لدى كتّاب تلك المرحلة نظرة مأساوية للواقع.
لقد حُرم رولفو من والده ثم والدته في طفولته، ونشأ مثل كثيرين من أبناء جيله في مؤسسات دينية أو شبه عسكرية. كانت المكسيك تشهد آنذاك عسكرةً للمجتمع، وتحولا عنيفا في بنيتها الزراعية والدينية، علاوة على طبيعة المكسيك بوصفها بلدا يواجه تحديات بيئية حادة، انعكست على عوالم رولفو الأدبية.
في قصته “لقد أعطونا الأرض”، مثلا، تتجلى المفارقة بين خطاب الثورة وواقع الفلاحين الذين يُجبرون، بعد سنوات من الكفاح والإقطاع، على الانتقال إلى أرض قاحلة. وبينما يحدثهم المسؤول الرسمي عن المساحة “الشاسعة” التي منحتها لهم الحكومة، يشيح عن الاستماع إلى شكواهم. لقد قطعوا أميالا حتى جفت حلوقهم، وها هم يقلبون أكفهم في حيرة، يمضغون الرمل وتذروهم الرياح في صحراء بلا أمل.
تنقلنا هذه المفارقة إلى “بيدرو بارامو”، ليبدو التغير الطفيف في العنوان إشارة إلى تكامل الرؤية. فالشخصيات التي لفحها الهجير، استحالت إلى أشباح معلقة بين الحياة والموت، تتنقل بين الذاكرة والمكان، دون أن تجد مخرجًا من مصيرها المحتوم، وهكذا جاءت نصوص هذا الجيل محمّلة بتلك القسوة المزدوجة. إنه الجيل الذي مهد لطفرة “الواقعية السحرية”، فإلى جانب رولفو، يمكن أن نذكر كتّابا مثل خوسيه ريفالتا، أو حتى البدايات الأدبية لأوكتافيو باث، الذين حاولوا استيعاب الصدمة القومية والذاتية لما بعد الثورة.
ومع رحيل الكاتب البيروفي الكبير ماريو فارغاس يوسا أخيرا، تتضح ملامح جيل أدبي فذ، استطاع أن يحول التجربة اللاتينية ـبما تحمله من ثورات فاشلة، وحكام دكتاتوريين، وشعوب ممزقة بين الأمل واللعنةـ إلى سرديات إنسانية، خلدها الأدب العالمي.
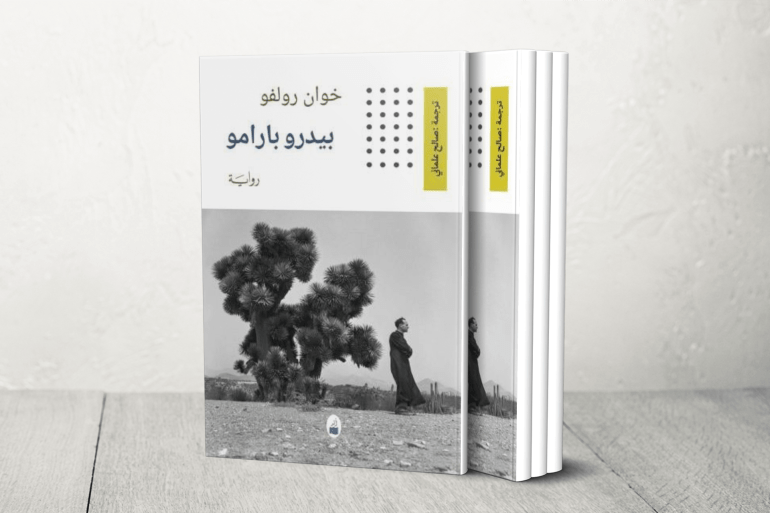
لعنة الانتظار
في واحدة من أشهر حكايات ألف ليلة وليلة، يُروى أن صيادا فقيرا ألقى شبكته في البحر أربع مرات، كعادته، فوقع في المرة الرابعة على قمقم نحاسي مختوم بخاتم سليمان. حين فتحه، خرج منه دخان كثيف تشكل شيئا فشيئا حتى صار جنيا هائلا يقف أمام الصياد مهددا بقتله. وحين سأله الصياد عن سبب هذا العقاب، قال الجني:
إني من الجن المارقين، غضب علي سليمان بن داود فحبسني في هذا القمقم، ورماه في قعر البحر. ومكثت مئة عام أقول: من يطلقني أغنيه إلى الأبد. ثم مئة أخرى: من يطلقني أكشف له كنوز الأرض. ثم مئة ثالثة قلت فيها: من يطلقني أحقق له ثلاث أمنيات. فلما طال انتظاري ولم يأت أحد، أقسمت أن أقتل من يخرجني ولا أحقق له شيئا!
أهي لعنة الانتظار الطويل؟ الغضب المتراكم عبر الأعوام؟ تمامًا كما حدث في كومالا، تلك البلدة التي تحولت إلى ذاكرة مغلقة على نفسها تحتضن ماضيها وتبتأس من حاضرها ولا أمل لديها في الخلاص. ربما لهذا تبتلع كل من يخطو إليها، كما عقيدة الجني في الفتك بالصياد البائس، لا لذنبٍ ارتكبه، بل لأنه وصل بعد فوات الأوان. هكذا يعرف البطل بموت أبيه وهو في أول الطريق من دليله الشبح الذي مات هو وحميره التي تتقدمهما، رغم ذلك يكمل الرحلة المقدرة، فإذا به يصبح فريسة للأرواح التي انتظرت طويلًا من يخلصها… فلما لم يأتِ أحد قررت الانتقام من البطل والقارئ على حد سواء.
لقد استطاع رولفو أن يجعل من “كومالا” مجازًا لكل البلاد التي خذلتها الوعود الكبرى. فالثورة المكسيكية، مثل كثير من الثورات، بشّرت بالعدالة والمساواة، لكنها خلّفت وراءها فراغًا موحشًا وأرواحًا تائهة. بهذا المعنى، لا تبدو كومالا حكرًا على المكسيك، بل تمتد ظلالها إلى أماكن عديدة: إلى المدن السورية التي مُحيت من الخرائط، وإلى الريف المصري الذي غنّى للثورة ثم اختنق في فقره، وإلى شوارع اليمن المعلّقة بين هدنة ومجاعة. تتبدل الأسماء والخرائط، لكن كومالا تبقى، مشحونة بأصداء ساكنيها المنسيين.
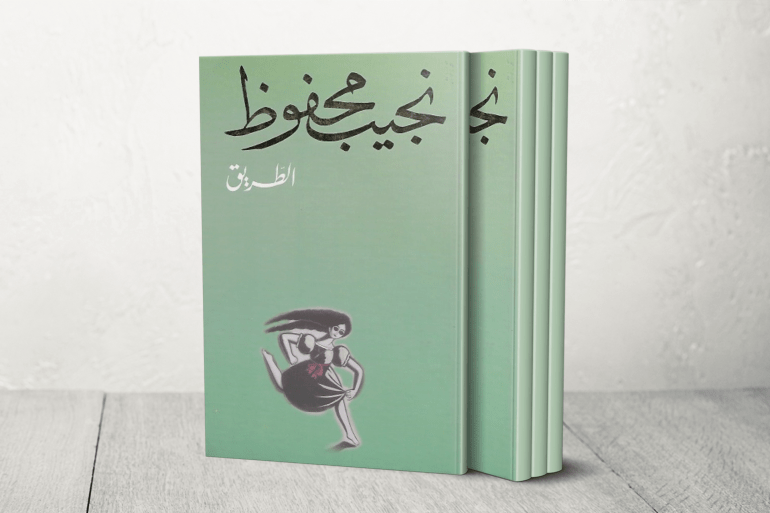
الحكي ضد الخذلان
في مواجهة النسيان، لم يكن أمام الكتّاب اللاتينيين سوى الحكي. ففي روايات ماركيز، وفوينتس، ورولفو، تتجلى المعاناة في شخصيات مسحوقة تحت وطأة الظلم الاجتماعي والسياسي، وهي صورة تتردد أصداؤها بوضوح في الأدب العربي. ليس من المستغرب إذًا أن يرى القارئ العربي في كومالا ملامح قريته المنسية، أو في أرواحها التائهة صدى لضحاياه هو، أو في أبطال رولفو شبها بأولئك الذين سكنوا روايات محمد شكري وجبرا إبراهيم جبرا، وعبد الرحمن منيف، ورضوى عاشور.
ورغم أن تأثير رولفو في الرواية العربية لم يُدرس بما يكفي، فإن بصمته تظهر بجلاء في بعض الأعمال المعروفة. لعل أبرزها الطريق لنجيب محفوظ، التي تُعد في بعض وجوهها صدى لرواية بيدرو بارامو، خاصة في تلك اللحظات الجوهرية: وصية الأم على فراش الموت، بالبحث عن الأب الغائب، رمز السلطة والمال.
كلا البطلين ينطلق إلى مكان لا يعرفه: كومالا في المكسيك، التي تحولت إلى بلدة يسكنها الأشباح، وعالم صابر القاهري، الذي يبدو كأنه مدينة صماء بلا معنى ولا ذاكرة. تتكرر المفارقة الموجعة: الأب الذي لا يمكن العثور عليه، والصورة التي يحملها الابن في جيبه تظل مستندا عاطلا من المعنى. أما النهاية، ففي كلا العملين، موت ينتظر البطل الذي دفعته أمه عبر رحلة مجهولة، ليحيا حياة كريمة.
هذا الاشتباك بين موت الأم، وغموض الأب، والرحلة العقيمة، والنهاية المأساوية، لا يكشف فقط عن أثر خوان رولفو في الكاتب النوبلي، بل يؤكد أن الأدب اللاتيني، في أكثر لحظاته صدقا، كان دائما الأقرب إلى الوجدان العربي؛ لا لتشابه المصائر وحده، بل لأننا، كما قال رولفو، “نولد محكومين بالخذلان، لكننا نستمر في الحكي”.

